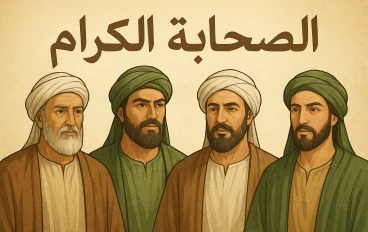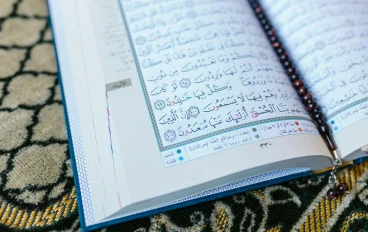إلغاء شعيرة عيد الأضحى قراءة في النص والسياق
تأجيل شعيرة الأضحية قراءة في النص والسياق
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وآله وصحبه والتابعين، وبعد:
قد علم بما لا يدع مجالا للشك أن الشريعة الإسلامية أساس مبناها قد أقامه الشارع الحكيم الرب الرحيم على الحِكَمِ والمصالح للعباد في المعاش والمعاد، وأنها عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عَدْل اللَّه بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتَمَّ دلالةٍ وأصدَقَها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهُدَاه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل))[1]( قال تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} [الأنعام: 115]. قال قتادة: صدقًا فيما قال، وعدلًا فيما حكم . يقول: صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مَفْسَدة، كما قال: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ [وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ]} إلى آخر الآية [الأعراف: 157])[2](.
والحديث عن مقاصد الإسلام فيه طرفان ووسط، فهناك الاتجاه الظاهري الذي يَقْصِر مسالك الكشف عن مقاصد الشارع على ما صرّحت به ظواهر النصوص دون أن يُعطي كبيرَ اهتمام لعلل الأحكام، والمقامات التي صدرت فيها، والظروف والملابسات التي صاحبتها، وما يمكن أن يكون لذلك من تأثير في فهمها وتنزيلها على ما يَجِدُّ بعد ذلك من وقائع.
وهناك الاتجاه المقابل له الذي يُهْدر ظواهر النصوص، ويسعى إلى التخلص منها بدعوى أنها ليست مقصودة لذاتها، ويجعل عمدته في اكتشاف مقاصد الشارع معاني باطنية يزعمها أصحاب هذا الاتجاه من غير أن تسندها أدلّة يُعتَدُّ بها، وإنما هي مجرد دعاوى ليست لها على أضدادها مزيّة. ويبرز هذا الاتجاه عند الفِرَق الباطنية القديمة ومن يُعدُّ امتدادًا لهم من بعض العلمانيين من المعاصرين الذين لم يجرؤوا على ردَّ النصوص الشرعية صراحة، فراموا التخلص منها بدعوى أنها لم يُقْصد منها ظواهرها، وإنما قُصِد بها تحقيق المصلحة التي تتغير بتغير الأزمان والظروف- نحو قول بعضهم العبادة جاءت لتهذيب الخلق فمن صلح خلقه وحسنت عشرته فقد استغنى بذلك عن الظواهر التعبدية .-!
والاتجاه الوسط، وهو اعتبار ظواهر النصوص ومعانيها في مسلك توافقي لا يسمح بإهدار أحد الجانبين على حساب الآخر ولا بطغيان أحدهما على الآخر؛ فيعطي للنص حقّه وأبعاده التي يكون قد قصدها الشارع، وذلك من خلال عدم إهمال الأدوات المُعِينة على حسن فهم النص وتطبيقه مِنْ عللٍ، وقرائنَ، ومقاماتٍ، وعقلٍ، وجمعِ النصوص الجزئيّة بعضها إلى بعض لتتضح الصورة الكلية))[3](.
من هذا المنطلق، هذه مناقشة لما صدر به الأمر السامي لأمير المؤمنين الملك محمد السادس بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد هذا العام -1446/2025- فذهب طرف إلى أن هذا تعطيل لشرع الله، وحد للحرية الدينية التي كفلها الشرع والقانون الذي يقر بأن المملكة دولة إسلامية، ويضمن حماية ممارسة الشعائر الدينية للمواطنين، وذلك من خلال الفصل الثالث من الدستور المغربي والذي ينص صراحة على أن الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية. وحيث يعد عيد الأضحى جزءًا من الشعائر الدينية التي تضمنها الدولة، فإلغاء هذه الشعيرة يعد حدا لهذا الشأن الديني، وهو مخالف لما جاء به الدستور المغربي.
وقال آخرون ليس فيه تعطيل لحكم شرعي، بل هو مقتضى المصلحة، وهو ما يتماشى مع روح الشريعة الإسلامية، لأن الأحكام الشرعية تدور مع عللها وجودًا وعدمًا، فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع التي تحول دون الوصول إلى مقصد الشارع الحكيم من مشروعية الأضحية، والتي أصبح أداؤها في ظل الوضع الراهن أشبه بالتكليف بما لا يطاق؛ فقد أضحت هذه الشعيرة في نظر فئة واسعة من المجتمع مصدر اغتناء فاحش وكانوا هم السبب الرئيس بعد موجة الجفاف في الوصول إلى هذه المرحلة، وذلك أن الوزارة الوصية قامت مشكورة بإحصاء القطيع للنظر في مدى ملائمة ما هو محصل عليه مع احتياجات السوق المحلية، فحصل تدليس وغش وكتم للحقائق الرقمية من طرف -الكسابة-، فلما صدر الأمر بإلغاء الشعيرة هذه السنة خرجوا يصرحون بما كانوا يخفون من قبل، ﵟ وَلَا يَحِيقُ ٱلۡمَكۡرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهۡلِهِۦۚ ﵞ ﵝفَاطِر : ﵓﵔﵜ.
الأسس الشرعية التي يبنى عيها قرار إلغاء شعيرة الأضحية
أولا- لازم عقد الإمامة والبيعة كما جاء في مستهل الرسالة الملكية "شعبي العزيز، لقد حرصنا، منذ أن تقلدنا الإمامة العظمى، مطوقين بالبيعة الوثقى..."..
أولا: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة )[4](.
قال تاج الدين السبكي:” كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة))[5](.
وقال شهاب الدين القرافي: «اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصيّة لا يحلّ له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة))[6](.
وقال العز بن عبد السلام: يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح، إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم، أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] ، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد))[7](.
للإشارة، كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الخميس 13 فبراير الجاري، أن "القطيع الوطني تراجع ب38 % مقارنة بسنة 2016".
2- البيعة: وهي أحد سمات التميز المغربي، فالبيعة الشرعية من خصائص الملة الإسلامية بحيث لا يعرف هذا النظام في الحضارات السابقة. ونظام البيعة في تقاليد أهل المغرب وأعرافهم يرتكز أساسا على مبدأ توثيق الحقوق والواجبات المتبادلة بين الراعي والرعية، وكأنه في روحه وجوهره يقصد إلى الأبعاد السامية في العدل والإنصاف.
ثانيا: القواعد الفقهية
1/ قاعدة المشقة تجلب التيسير.
فالأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرجٌ على المكلف، ومشقة في نفسه، أو ماله؛ فالشريعة تخفِّف في تلك الأحكام؛ وليس لأحد منة في ذلك فهو حكم الله تعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من القرآن قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]. وقال تعالى:﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]. وقال أيضا:﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة: 286].
وأما من السنة: عن هريرة، قال: قال صلى الله عليه وسلم: (إنما بُعثتم ميسِّرين، ولم تبعثوا معسِّرين))[8](. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرِهوا عليه))[9](.
وعن عائشة - رضي الله عنها -: ما خُيِّر النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه))[10](.
ومن هنا تَبيَّن لنا أن رفع الحرج عن المكلفين مقصد تشريعي؛ قال الشاطبي رحمه الله: (اعلم أن الحرجَ مرفوع عن المكلفين؛ لوجهين:
أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق، وبُغض العبادة، وكراهة التكليف، وينتظم تحت هذا المعنى: الخوفُ من إدخال الفساد على المكلف في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله؛ وذلك لأن اللهَ وضع هذه الشريعة حنيفية سمحة سهلة، حفِظ فيها على الخَلق قلوبهم، وحبَّبَها لهم بذلك؛ فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة، لدخل عليهم فيما كلِّفوا به ما لا تخلُصُ به أعمالهم.
والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع، مثل قيامه على أهله وولده، إلى تكاليف أُخر تأتي في الطريق، فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلًا عنها، وقاطعًا بالمكلف دونها، والمكلف مطلوبٌ بأعمال ووظائف شرعية لا بد له منها، ولا محيص له عنها، يقوم فيها بحق ربه تعالى، فإذا أوغل في عمل شاقٍّ فربما قطَعه عن غيره، ولا سيما حقوق الغير التي تتعلق به، فتكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعًا عما كلفه الله به، فيقصر فيه، فيكون بذلك ملومًا غيرَ معذور؛ إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا يخلُّ بواحدة منها، ولا مجال من أحواله فيها))[11](.
2/ قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة.
قال الشاطبي: "وأما الحاجيات، فمعناها أنه مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، وإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة، ولكن لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصلحة العامة))[12](.
والحديث هنا عن المشقة التي تكون باعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي العام هي المشقة البالغة درجة الحرج والمشقة غير المعتادة) )[13](.
والمعتبر في تقدير الحاجة حالة الشخص المتوسط العادي في موضع معتاد لا صلة له بالظروف الخاصة به؛ لأن التشريع يتصف بصفة العموم والتجريد.
واشترط بعض العلماء للتمسك بالمصالح الحاجية أن يشهد لها أصل بالاعتبار، فلا يجوز للمجتهد إذا ما لاحت له مصلحة حاجية أن يعتبرها ويبني عليها الأحكام، ما لم يجد لها شاهدًا من جنسها؛ إذ لو لم يعتبر هذا القيد لترتب على ذلك مفاسد كثيرة؛ لأن الاستناد إلى مجرد الحاجة - من دون أصل شرعي يشهد لاعتبارها - يعد رأيًا مجردًا ووضعًا للشرع بالرأي، كما أنه يؤدي إلى استواء العالِم والأمي؛ لأن كل واحد يعرف مصلحة نفسه، ولَمَا كانت هناك حاجة لإرسال الرسل))[14](.
3/ اجتهاد الحاكم
اجتهاد الحاكم في مثل هذه الحالة وهي تأجيل شعيرة الأضحية مع الحفاظ على متعلقاتها من صلاة العيد وصلة الأرحام ونحو ذلك هو اجتهاد فقهي محكوم بمقاصد الشريعة، حيث تتحقق الغاية الأساسية من العيد.
فالشريعة الإسلامية تتميز بالمرونة بما يتناسب مع المستجدات، فإذا تغير العلة تغير الحكم تبعا لها، لأن الحكم الشرعي يدور مع العلة وجودًا وعدمًا.
فهل أخطا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين عطل العمل بحد السرقة في عام المجاعة؟ أوحين عطل حق المؤلفة قلوبهم في الزكاة، العلماء لم يذكروا أن أحدا من الصحابة خطأ فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا اتهمه بمخالفة الوحي، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم شرعا معلقا بسبب إنما يكون مشروعا عند وجود السبب كإعطاء المؤلفة قلوبهم فإنه ثابت بالكتاب والسنة، وبعض الناس ظن أن هذا نسخ لما روي عن عمر أنه ذكر أن الله أغنى عن التأليف، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، وهذا الظن غلط، ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم فترك ذلك لعدم الحاجة إليه لا لنسخه كما لو فرض أنه عٌدم في بعض الأوقات ابن السبيل، والغارم ونحو ذلك))[15](.
وقال القاضي ابن العربي: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، فإن في الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ) )[16](.
وأيضا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يعطل حدا من حدود الله !
قال علقمة: كنّا في جيش في أرض الروم، ومعنا حذيفة بن اليمان، وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر، فأردنا أن نحدَّه، فقال حذيفة: أتحدُّون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم؟.
وليس في هذا ما يخالف نصًّا ولا قياسًا ولا قاعدةً من قواعد الشرع ولا إجماعًا، بل لو ادُّعي أنه إجماع الصحابة كان أصوب.
أكثر ما فيه تأخير الحدّ لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار، وتأخير الحدّ لعارضٍ أمر وردت به الشريعة، كما يؤخَّر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض؛ فهذا تأخير لمصلحة المحدود؛ فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى.
فالظاهر أن سعدا رضي الله عنه اتبع في ذلك سنة الله عز وجل؛ فإنه لما رأى تأثير أبي محجن في الدين وجهاده وبذْله نفسَه لله ما رأى درأ عنه الحدَّ؛ لأن ما أتى به من الحسنات غَمرتْ هذه السيئة الواحدة وجعلتْها كقطرة نجاسةٍ وقعت في بحر، ولا سيّما وقد شامَ منه مخايلَ التوبة النصوح وقت القتال؛ إذ لا يُظَنُّ في مسلم إصرارُه في ذلك الوقت الذي هو مظِنَّة القدوم على الله وهو يرى الموت.
وأيضًا فإنه بتسليمه نفسَه ووَضْعِ رجلِه في القيد اختيارًا قد استحق أن يُوهَب له حدُّه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: يا رسول الله، أصبتُ حدًّا فأقِمْه عليّ، فقال: «هل صلَّيتَ معنا هذه الصلاة؟» قال: نعم، قال: «اذهَبْ فإن الله قد غفر لك حدَّك». وظهرَ بركةُ هذا العفو والإسقاط في صدق توبته، فقال: «والله لا أشربها أبدًا ــ وفي رواية: أبدَ الأبدِ ــ قد كنت آنَفُ أن أتركَها من أجلِ جَلداتِكم، فأما إذ تركتموني فوالله لا أشربها أبدًا»( )[17](.
قال ابن القيم: "ومقتضى قواعد الشرع إذا كانت السنة سنة مجاعة وشدة، غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له إما بالثمن أومجاناً على الخلاف في ذلك، والصحيح وجوب بذله مجاناً؛ لوجوب المواساة، وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك، والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج) )[18](. فَعُلِم أن هذا من باب السياسة الشرعية.
هل تأجيل الأضحية هذه السنة بدعة محدثة؟
شهد المغرب خلال حكم الملك الحسن الثاني-رحمه الله-، وذلك عام 1963 بسبب “حرب الرمال” مع الجزائر، وفي عام 1981 خلال أزمة اقتصادية خانقة، ثم عام 1996 بسبب الجفاف الذي أدى إلى انخفاض كبير في أعداد الماشية.
تشريع الأضحية وعيد الأضحى يحمل في طياته العديد من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية، منها تعزيز الإيمان، تحقيق التكافل الاجتماعي، نشر السعادة، والتذكير بالتضحية والإيثار. هذه المقاصد تعكس حكمة الله - سبحانه وتعالى - في تشريع العبادات، وهي تهدف إلى تحقيق المصالح الدينية والدنيوية للمجتمع المسلم. والملاحظ أنها في ظل الظروف الحالية لم يعد هم الآباء الحرص على هذه المقاصد، بقدر ما يهدف إلى اسكات أطفاله أو إرضائهم تماشيا مع ظروف الجيران، أو دفعا للوم والعتاب. فصار أمر الأضحية يراعى فيه الضغط المجتمعي أكثر مما ينظر فيه الى المقاصد الشرعية، فهل تحلو أضحية مع غصة القرض الربوي؟ أو يفرح لعيد مع دين الخروف؟.
المراجع
([1]) إعلام الموقعين عن رب العالمين(ج1ص41) ، محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) ، تحقيق مشهور حسن سلمان، طبعة دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة : الأولى، 1423 هـ. بتصرف.
([2]) تفسير القرآن العظيم (ج3 ص 322)، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق : سامي بن محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض – السعودية. الطبعة: الثانية، 1420 هـ - 1999 م.
([3]) طرق الكشف عن مقاصد الشارع (ص 11) ، الدكتور نعمان جغيم، الناشر : دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن
الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م. بتصرف يسير
([4]) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 83).
([5]) الأشباه والنظائر تاج الدين السبكي (ج1 ص 310)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى 1411 هـ - 1991 م
([6]) ترتيب الفروق واختصارها (ج 2ص 295)، محمد بن إبراهيم البقوري، تحقيق: الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، عام النشر: 1414 هـ - 1994 م
([7]) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ج2ص89)، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة.
([8]) أخرجه البخاري 1/ 89.
([9]) أخرجه ابن حبان صحيح ابن حبان- (16/ 202)..
([10]) أخرجه مسلم ( ج15 ص83).
[11]) الشاطبي، الموافقات، (ج2، ص136).
([12]) الشاطبي، الموافقات، (ج2، ص11).
([13]) الوجيز في أصول استنباط الأحكام للدكتور محمد عبداللطيف الفرفور: (2/ 2653).
([14]) انظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة: 3/ 207. الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسير، ص 508 - 509.
([15]) مجموع الفتاوى (ج33 ص94)، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة – السعودية، عام النشر: 1425 هـ - 2004 م
([16]) أحكام القرآن (ج2 ص530)، القاضي أبو بكر بن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.
([17]) أعلام الموقعين عن رب العالمين (ج3ص437)، ابن قيم الجوزية تحقيق (محمد أجمل الإصلاحي)، الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)، الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م بتصرف.
([18]) أحكام أعلام الموقعين عن رب العالمين (ج3ص443)، ابن قيم الجوزية تحقيق (محمد أجمل الإصلاحي)، الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)، الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م بتصرف.