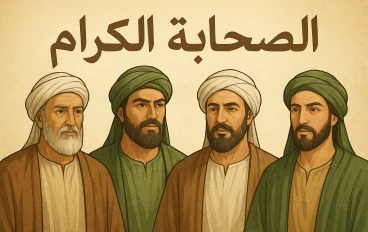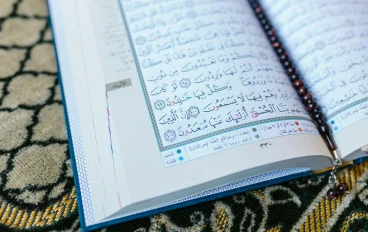خطورة الاستشراق الجديد على المجتمعات الإسلامية
المقدمة:
شهد القرن الحادي والعشرون تحوّلًا نوعيًا في العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي، انعكس في بروز "الاستشراق الجديد" كنسق فكري يتجاوز الاستشراق الكلاسيكي في مجالاته وأهدافه. ففي حين اقتصر الاستشراق القديم على دراسة اللغات والآداب والتاريخ، فإن الجديد منه يرتكز على أدوات تحليلية وسياسية معقّدة، تستهدف البنية الفكرية والثقافية للعالم الإسلامي.
تُشكّل هذه الموجة الاستشراقية امتدادًا لمشروع الهيمنة المعرفية، لكنها أكثر خطورة ومرونة، حيث تسوّق نفسها من خلال المراكز البحثية، والمؤتمرات الدولية، والشراكات الأكاديمية. هنا، لا يعود الهدف مجرّد "فهم الشرق" كما كان في السابق، بل يصبح إنتاج معرفة تخدم الأجندات السياسية والأمنية الغربية.
ويأتي هذا المقال لتسليط الضوء على خطورة الاستشراق الجديد على المجتمعات الإسلامية، من خلال رصد سماته، وتحليل ممارساته، واستعراض مظاهر تأثيره في الإعلام والتعليم والسياسة. كما يُبرز التحديات التي يفرضها هذا التوجّه على الهوية الثقافية الإسلامية، ويقترح مداخل للمواجهة الفكرية والمعرفية.
أولا: السمات الفكرية للاستشراق الجديد:
الاستشراق الجديد لا يُمكن اختزاله في مجرد دراسات أكاديمية حول الشرق، بل هو منظومة فكرية متعددة الأبعاد. يتميز بعدة سمات جعلته أكثر تأثيرًا وعمقًا مقارنة بالاستشراق التقليدي، منها:
1 - التمويه الأكاديمي والمنهجي:
حرص منظّرو هذا التيار على إبراز أعمالهم بصيغة "علمية محايدة"، رغم احتوائها على دوافع ثقافية وأيديولوجية، تهدف لتشكيل وعي سلبي حول الإسلام. مثال ذلك تقارير مؤسسة RAND التي تُروّج لـ"إسلام معتدل" كأداة لصياغة سياسة خارجية أمريكية تجاه المسلمين RAND Corporation, 2004)).
2- التخصصات المتداخلة:
لم يعد الاستشراق حكرًا على التاريخ أو الفقه المقارن، بل أصبح يُمارس من خلال علم النفس السياسي، وعلم الاجتماع، واللسانيات، والأنثروبولوجيا. فالدراسات التي تُحلل سلوكيات المجتمعات الإسلامية من منظور "ثقافي-أمني"، تُوجّه السياسات بناءً على ما يُفهم من السياق المحلي.
3- تحليل العقل المسلم والهوية الدينية:
يركّز هذا التيار على دراسة "العقل الإسلامي" من خلال فرضيات تتعلق باللاعقلانية، ورفض الحداثة، والانغلاق. برنارد لويس مثلًا، اعتبر أن سبب تخلف المسلمين يعود إلى "فشلهم في اللحاق بالركب الغربي" (Lewis, 2002)، وهو تأطير يفترض تفوق الغرب معرفيًا وأخلاقيًا.
4 - خطاب إنقاذي مموّه:
يُقدِّم الاستشراق الجديد الإسلام بوصفه دينًا مأزومًا، والمجتمعات الإسلامية كضحايا لـ"ثقافة التخلف"، ما يُبرر التدخلات الإصلاحية الخارجية. وهذا النوع من الخطاب يفتح المجال أمام مشاريع التغريب والوصاية الثقافية.
كل هذه السمات تجعل من الاستشراق الجديد مشروعًا ناعمًا للهيمنة، لا يَستخدم الجيوش، بل يشتغل عبر الخطاب والمعرفة، ويعيد تشكيل وعي المسلمين بصورة تدريجية ولكن خطرة.
ثانيا- تشويه صورة الإسلام وصناعة الإسلاموفوبيا:
بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، شهد العالم الغربي تحوّلًا كبيرًا في طريقة تناوله للإسلام، حيث تصاعد الخطاب الاستشراقي ضمن إطار أمني وثقافي يستهدف إعادة تشكيل الوعي الغربي والعالمي تجاه الدين الإسلامي. وقد كان للاستشراق الجديد دور مركزي في هذا التحول، حيث أنتج خطابًا يُجرّم الإسلام ثقافيًا ويُشكّك في مقاصده الحضارية.
1- ربط الإسلام بالإرهاب:
أصبحت وسائل الإعلام الغربية منصة لتكرار سرديات تربط الدين الإسلامي بالعنف والتطرّف. استخدم كثير من المحللين والمفكرين مصطلحات مثل "الإسلام السياسي العنيف" أو "الخطر الإسلامي"، ما ساهم في ترسيخ مفاهيم خاطئة عن الإسلام. في هذا السياق، ساعدت كتابات هنتنغتون على نشر مفهوم "صدام الحضارات" الذي يرى أن الإسلام يمثّل تهديدًا حضاريًا للغرب (Huntington, 1996).
2- الترويج للإسلاموفوبيا كمناخ ثقافي عام:
لم تقتصر تأثيرات هذا الخطاب على المجال الأكاديمي فحسب، بل انعكست على السياسات العامة، مثل قوانين منع الحجاب في فرنسا، أو التضييق على المساجد في أوروبا. تُشير تقارير _Amnesty International_ (2022) إلى أن المسلمين هم أكثر الفئات استهدافًا بجرائم الكراهية في عدة دول أوروبية.
3- إنتاج المحتوى الثقافي والسينمائي الموجّه:
ساهمت الصناعة السينمائية والبرامج الوثائقية الغربية في إنتاج صورة نمطية عن المسلم، غالبًا ما يظهر فيها كإرهابي، أو متشدّد، أو غريب ثقافيًا. على سبيل المثال، حلّلت دراسة في _Journal of Communication_
(Ali & Nisar, 2020)أكثر من 100 فيلم هوليوودي، ووجدت أن 68٪ منها تُقدّم شخصيات مسلمة في إطار سلبي أو عدائي.
هذه الأبعاد تُظهر كيف تجاوز الاستشراق الجديد حدود النظرية ليتحوّل إلى مشروع ثقافي متكامل، يُسهم في بناء بيئة من الخوف والرفض تجاه الإسلام والمسلمين.
ثالثا: اختراق النخب الفكرية والمناهج التعليمية
يمثّل اختراق النخب الفكرية في العالم الإسلامي أحد أبرز تجليات الاستشراق الجديد، حيث يسعى لإعادة تشكيل الخطاب الثقافي والديني من الداخل، لا من خلال المواجهة المباشرة، بل عبر التغلغل "الناعم" في البنية الفكرية والتعليمية.
1- استقطاب الباحثين المحليين:
تقدّم مراكز بحثية غربية فرصًا بحثية وتمويلات سخية للباحثين من دول إسلامية، مثل مؤسسة "كارنيغي" ومعهد "بروكينغز"، غالبًا مع توجيه غير مباشر نحو موضوعات محددة تتماشى مع الأجندة الاستشراقية مثل "إصلاح الإسلام"، "دور المرأة المسلمة"، أو "العلاقة بين الدين والديمقراطية". وقد أشارت دراسة نُشرت في _Middle East Critique_ إلى أن هذا النوع من التعاون يؤدي أحيانًا إلى "إعادة إنتاج الاستعمار المعرفي". (Elshamsy, 2021)
2- إعادة تشكيل المناهج الجامعية:
تمتد تأثيرات الاستشراق الجديد إلى التعليم الجامعي، حيث تُعقد شراكات بين جامعات غربية ونظيراتها في العالم الإسلامي، تؤدي إلى إدراج مقررات تُركّز على "الحداثة الغربية" وتُهمّش التراث الإسلامي. مثال ذلك مشروع "TEMPUS" الذي موّل إصلاحات تعليمية في الجامعات العربية مع التركيز على "مواكبة الخطاب المعرفي العالمي" (EU Commission, 2015).
3- استنساخ المفاهيم الغربية دون نقد:
يتبنى بعض الأكاديميين العرب مفاهيم مثل "التنوير"، و"التقدم"، و"العقلانية" كمُسلّمات، دون مساءلتها أو تكييفها مع السياق المحلي، ما يُؤدي إلى إنتاج "حداثة مزيفة" لا تنبع من حاجات المجتمعات الإسلامية، بل تُكرّس التبعية الفكرية والثقافية للغرب (Al-Jabri, 1991).
هذا التغلغل في النخب والمؤسسات التعليمية يُسهم في إعادة بناء التصورات الثقافية من الداخل، ويُشكّل خطرًا ناعمًا يُمهد الطريق لتفكيك المرجعيات الإسلامية عبر أدوات التعليم والمعرفة.
رابعا: الاستشراق الجديد كأداة سياسية وأمنية
لا يُمكن فهم الاستشراق الجديد دون إدراك ارتباطه العميق بمشاريع الهيمنة السياسية والأمنية التي تنتهجها القوى الغربية تجاه العالم الإسلامي. ففي العقود الأخيرة، تحول هذا التيار من مجرد تحليل ثقافي إلى توجيه عملي للقرارات السياسية والاستراتيجيات الأمنية.
1- الاستشراق كمصدر لصناعة القرار:
تلجأ مؤسسات حكومية غربية مثل وزارة الدفاع الأمريكية ومجلس الأمن القومي إلى تقارير تصدرها مراكز بحثية استشراقية لوضع السياسات المتعلقة بالشرق الأوسط. من أبرز هذه التقارير، تلك التي صدرت عن مؤسسة RAND، حيث اقترحت تصنيف المسلمين إلى "متطرفين، ومعتدلين، وتقدميين" (RAND, 2007)، مع دعوة إلى دعم الفئة الأخيرة عبر الإعلام والتعليم.
2- الدفع نحو إعادة تشكيل الخطاب الديني:
تشجع مشاريع الاستشراق الجديد على "إعادة قراءة النصوص الإسلامية" وفق معايير ليبرالية غربية، ويتم ذلك عبر دعم حركات إصلاحية داخلية، أو عبر توفير منصات لمثقفين يتبنّون خطابًا يتماشى مع السياسات الغربية. كما يشير الباحث أبو الربيع إلى أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى "تفكيك المرجعية الدينية وتحييدها سياسيًا"
. (Abu-Rabi, 2007)
3- الاستشراق كأداة هيمنة ناعمة:
لا يقتصر تأثير الاستشراق الجديد على النُخب فحسب، بل يمتد إلى الإعلام والثقافة الشعبية. يتم تسويق بعض المفاهيم عبر برامج وثائقية ومنشورات رقمية على مواقع التواصل، بأسلوب جذاب يُخفي الطابع الاستشراقي ويُقدّم نفسه على أنه "تنوير حضاري".
وتؤكد وثائق _Wikileaks_ المسربة عام 2011، أن العديد من السفارات الغربية تستند في تقاريرها إلى تحليلات استشراقية حول القوى الدينية والاجتماعية في العالم الإسلامي، وتُستخدم تلك المعلومات لتقييم الأوضاع الداخلية وتحديد أولويات التدخل.
هذا الاستخدام الواسع للاستشراق الجديد بوصفه أداة استراتيجية يُبرز خطورته كمشروع عابر للتخصصات، يُوظف المعرفة لأغراض الهيمنة وإعادة صياغة الهُوية الإسلامية وفق مصالح غير محايدة.
خامسا: الاستشراق التوراتي والصهيوني
يمثل الاستشراق التوراتي والصهيوني أحد أخطر امتدادات الاستشراق الجديد، نظرًا لتوظيفه المباشر في دعم المشروع الاستعماري الصهيوني وتبرير الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وهو لا يكتفي بتحليل ثقافي أو ديني، بل يُعيد بناء التاريخ والهوية بناءً على سرديات توراتية تُلغي الوجود العربي والإسلامي.
1- إعادة كتابة التاريخ الفلسطيني:
يرتكز الاستشراق الصهيوني على إنكار الوجود الفلسطيني التاريخي، وتصوير أرض فلسطين على أنها "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". وتُستخدم دراسات أثرية ولغوية موجهة لإثبات "الحق اليهودي" في الأرض، دون اعتبار للحق العربي والإسلامي الراسخ. وقد كشف الباحث عصام نصار في ورقته _فلسطين في الاستشراق التوراتي_ عن نماذج من التزييف المنهجي الذي مارسه مستشرقون يهود لتبرير الاحتلال (Nassar, 2025).
2- تحييد البُعد الإسلامي للقدس:
يسعى الاستشراق التوراتي إلى طمس الهوية الإسلامية لمدينة القدس، من خلال التركيز الحصري على الرواية اليهودية التوراتية، وإقصاء الموروث الإسلامي المسيحي العربي. هذا التحييد يتجلى في إنتاج خرائط وكتب سياحية وأدلة تاريخية لا تتناول سوى التاريخ العبري، مما يُرسّخ تصورًا استبعاديًا للهوية الجامعة للمدينة.
3- تطويع الدراسات الأكاديمية لخدمة الاحتلال:
تنتج جامعات إسرائيلية وشركاؤها في الغرب دراسات تُصور المقاومة الفلسطينية باعتبارها "أصولية دينية"، وتُحاول نزع الشرعية عنها من خلال تأطيرها في خطاب استشراقي "عدائي". وقد وثّقت تقارير _B’Tselem_ و _Human Rights Watch_ كيف يتم استخدام هذا النوع من الدراسات لتبرير انتهاكات الاحتلال تحت غطاء "مكافحة الإرهاب".
هذا التوجّه الاستشراقي الصهيوني لا يكتفي بالإنتاج المعرفي، بل يُوجّه السياسات الدولية من خلال تسويق رواية إسرائيلية تُهمّش الآخر وتُعزز التوسع الاستيطاني، ما يُظهر خطورة هذا النمط بوصفه مشروعًا سياسيًا استيطانيًا مغلفًا بلغة البحث الأكاديمي.
سادسا: الاستشراق الجديد والإعلام الرقمي
في العصر الرقمي، شهد الاستشراق تحوّلًا نوعيًا في أدواته ووسائطه، حيث لم تعد الكتب والأبحاث الأكاديمية وسيلته الوحيدة، بل باتت المنصات الرقمية والتقنيات الذكية قنوات جديدة لبث الخطاب الاستشراقي وتكريسه في وعي الأفراد، خاصة لدى فئة الشباب.
1- توسيع نطاق التأثير عبر الإعلام الرقمي
توظّف مؤسسات بحثية وإعلامية خطابًا استشراقيًا ناعمًا على الإنترنت، من خلال مواقع تحليل سياسي ومنصات تعليمية تنشر محتوى موجهًا، يُقدّم الإسلام كدين جامد أو متناقض مع الحداثة. وغالبًا ما يُدمج هذا الخطاب داخل تقارير أو عروض مرئية تُقدّم بلغة جذابة مدعومة بالرسوم البيانية والتقنيات البصرية، مما يعزز من تأثيرها على المتلقي.
2- استهداف الشباب المسلم
أصبحت المنصات الاجتماعية مثل يوتيوب، إنستغرام، وتيك توك أدوات فعّالة لبث محتوى استشراقي على هيئة فيديوهات قصيرة أو بودكاستات، يظهر فيها باحثون أو مؤثرون يقدّمون آراء مغلفة بلغة علمية، لكنها في جوهرها تعيد إنتاج الصور النمطية عن الإسلام. وتُظهر دراسة لـ _Pew Research Center_ (2023) أن 61٪ من الشباب المسلمين في الغرب تعرضوا لرسائل سلبية عن الإسلام من خلال المنصات الرقمية.
3- الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات
بدأت بعض مراكز الفكر الغربية باستخدام أدوات تحليل البيانات الضخمة لرصد ميول المجتمعات الإسلامية رقمياً، وتحديد الاتجاهات الفكرية والسياسية فيها. هذه التحليلات تُستخدم لاحقًا لتوجيه رسائل ثقافية أو سياسية محسوبة، مما يجعل من الاستشراق الجديد مشروعًا رقميًا ذكيًا يتجاوز نطاق المعرفة ليتحول إلى أداة تأثير اجتماعي دقيق.
هذا التوسع في الإعلام الرقمي يعكس قدرة الاستشراق على التكيف مع متغيرات العصر، ويُبرز أهمية بناء حضور رقمي مسلم قادر على تقديم رواية ذاتية مستقلة وعميقة.
سابعا: سبل المواجهة الفكرية والمعرفية
تفرض خطورة الاستشراق الجديد ضرورة بلورة استراتيجية فكرية ومعرفية شاملة، تهدف إلى التصدي له ليس فقط بردود فعل دفاعية، بل بإنتاج بدائل ثقافية قادرة على تشكيل وعي مستقل ومتماسك. ويمكن تلخيص أبرز سبل المواجهة في الآتي:
1- إنتاج المعرفة الأصيلة
ينبغي تشجيع الباحثين المسلمين على تقديم قراءات علمية نابعة من السياق المحلي، تراعي الواقع الحضاري والديني للأمة. يتطلب ذلك تأسيس مراكز بحثية مستقلة، وتوفير دعم مادي ومعنوي للأكاديميين، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية. وقد نجحت بعض المؤسسات مثل _مركز البيان للبحوث والدراسات_ في تقديم نماذج أولية واعدة (الوهيبي، 1435هـ(.
-2 تعزيز القراءة النقدية
من الضروري تربية الأجيال على التفكير النقدي تجاه الخطابات الوافدة، من خلال إدراج مادة "فكر استشراقي ونقده" في المناهج الجامعية. كما يجب تدريب الطلبة على تحليل المصادر الغربية ومساءلتها علميًا دون انبهار أو رفض مطلق، وفق ما أشار إليه إدوارد سعيد في كتابه "الاستشراق" (Said, 1978).
-3إحياء الإعلام البديل
يتطلب الرد على الاستشراق الرقمي بناء منصات إعلامية حديثة، تُخاطب العالم بلغات متعددة، وتُقدّم سرديات تتسم بالعمق والدقة. ومن الأمثلة الرائدة في هذا السياق شبكة الجزيرة، التي أثرت الخطاب النقدي تجاه الاستشراق في برامج مثل "موازين" و"ما خفي أعظم".
-4توطين المفاهيم وتطويرها
بدلًا من استنساخ المفاهيم الغربية، ينبغي تطوير مفاهيمنا الدينية والحضارية بطريقة تتفاعل مع العصر دون أن تفقد جذورها. فالتقدم لا يعني الانفصال عن التراث، بل توسيع أفقه وتحريره من الجمود، كما أشار الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري (الجابري، 1991.(
إن هذه السبل ليست حلولًا مؤقتة، بل مداخل استراتيجية لإعادة بناء الذات الحضارية وتمكينها من مواجهة الخطاب الاستشراقي بأدوات فكرية راشدة وعميقة.
خاتمة:
يتضح من تحليل مسارات الاستشراق الجديد أنه تجاوز كونه مجالًا معرفيًا يتناول "الشرق" في صورته التقليدية، ليصبح مشروعًا مركّبًا ومتعدد الوسائط يسعى إلى تشكيل الوعي وإعادة بناء صورة الإسلام وفقًا لمعايير تخدم الهيمنة الثقافية والسياسية الغربية. فالتحوّل من البحث الأكاديمي إلى الممارسة السياسية والتأثير الإعلامي يكشف عن خطورة هذا التوجه في التعامل مع المجتمعات الإسلامية.
لقد تبيّن أن الاستشراق الجديد يوظف أدوات ذكية؛ من مراكز الفكر وصياغة المناهج، إلى منصات الإعلام الرقمي، مرورًا بتطويع التاريخ والثقافة لتبرير مشاريع استعمارية، كما هو الحال في الاستشراق التوراتي والصهيوني. وهذه الأدوات تعمل بأسلوب ناعم لا يصطدم مباشرة بالهوية الإسلامية، بل يسعى لتفكيكها من الداخل عبر تطبيع خطابات دخيلة.
بالمقابل، فإن مواجهة هذا المشروع لا تتحقق بمجرد فضحه أو مهاجمته، وإنما عبر تبني مداخل معرفية نقدية تُنتج خطابًا أصيلًا يعكس واقع الأمة وينطلق من مرجعياتها. ومن أهم هذه المداخل: تأسيس منصات بحثية مستقلة، تطوير الإعلام البديل، إعداد مناهج تعليمية تستعيد الوعي التاريخي والديني، وتأهيل النخب الفكرية على القراءة النقدية والمقارنة الواعية.
وختامًا، فإن رصد خطورة الاستشراق الجديد لا يُعد ترفًا فكريًا، بل ضرورة استراتيجية لبناء استقلال حضاري يستند إلى الأصالة والانفتاح في آنٍ واحد. وإذا كانت المعرفة أداة للهيمنة، فإن المقاومة المعرفية تشكّل بداية التحرر الثقافي، وتفتح الطريق أمام خطاب إسلامي عالمي جديد لا يُكرر المقولات القديمة، بل يُعيد صياغة ذاته من موقع الفاعلية والوعي.
قائمة المصادر والمراجع
1- الوهيبي، عبد الله بن عبد الرحمن. _حول الاستشراق الجديد: مقدمات أولية_. مركز البيان للبحوث والدراسات، الرياض، 1435هـ.
2- سعيد، إدوارد. _الاستشراق_. ترجمة: كمال أبو ديب. مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط1، 1978م.
3- الجابري، محمد عابد. _نحن والتراث: قراءات معاصرة في التراث العربي الإسلامي_. المركز الثقافي العربي، بيروت، 1991م.
4- نصر، عصام. "فلسطين في الاستشراق التوراتي"، ورقة بحثية مقدّمة إلى المؤتمر الدولي حول الاستشراق الجديد، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، 2025م.
5- أبو الربيع، إبراهيم. "اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر"، _مجلة الدراسات الإسلامية المعاصرة_ ، العدد (12)، المجلد (1)، 2007م، ص1–19.
6- علي، سارة، نصار، هاني. "هوليوود والمسلمون: دراسة للصور السلبية في الأفلام الشعبية"، _مجلة الإعلام والاتصال_ ، المجلد (45)، العدد (2)، 2020م، ص123–140.
7- قناة الجزيرة. "الاستشراق الجديد: أداة للهيمنة على المجتمعات وإخضاعها"، برنامج _موازين_ ، الدوحة، 2024م.
8- وثائق ويكيليكس. _US Diplomatic Cables Concerning Islam and Middle East Policy_. https://wikileaks.org، 2011م.
9. -Lewis, Bernard. _What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response_. Oxford University Press, Oxford, 2002.
10.- Huntington, Samuel P. _The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order_. Simon & Schuster, New York, 1996.
11.- RAND Corporation. _Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies_. Santa Monica, CA, 2004.
12.- RAND Corporation. _Building Moderate Muslim Networks_. Santa Monica, CA, 2007.
13.- Amnesty International. _Islamophobia in Europe: A Growing Threat to Rights_. Amnesty Publications، لندن، 2022.
14.- Elshamsy, Hadeer. "Postcolonialism or Neo-colonialism? Academic Aid Programs in MENA Universities". _Middle East Critique_, Vol. 30, No. 3, 2021, pp. 215–229.
15.- Smith, D. & Kassem, R. "Educational Partnerships and Identity Formation in Arab Universities". _Third World Quarterly_, Vol. 40, No. 6, 2019, pp. 1075–1092.
16.- European Commission. _TEMPUS Programme and Academic Reform in the Arab World_. Brussels, EU Commission, 2015.