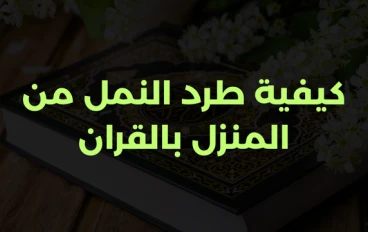مبلغ مدارك الفلاسفة اليونانيين بالمسألة النفسية
الإنسان شديد الحرص على حياته، كبير الكلف بذاته، لا يقنعه غير أن يكون مخلدا لا يموت. ومدركاً لا يعتريه الخمود. وهو شعور فطري غرزه الخالق في طبيعة الإنسان كما غرز فيه سائر العواطف الأخرى، لا تمحوه من جوهره شدائد الشيخوخة، ولا تؤثر عليه تارات المحن؛ بل ربما زادته شرهاً على شره، وأكسبته نهما على نهم.
يرى الإنسان نفسه حيا مدركا، تتلألأ في معناه الإنساني أشعة الشعور والحياة، وتستطيع في وجدانه أنوار المدركات والأفكار، وهو بهذه الصفة سلطان الطبيعة يصرفها بفكره وقائد الخليقة يقودها إلى مصالحها، ثم تحين منه التفاتة فيرى سكان المقابر في سكوت وبهوت، قد زجوا إلى شقوق من الأرض كانوا يعافون النظر إليها وهم أحياء، ويتشاءمون من المرور بها وهم أصحاء، فتأخذه قشعريرة باطنية.
هل يستوي العالم الذي يملأ طباق الأرض علما، والجاهل الذي شوه وجه الإنسانية إثما؟ إذن فالحيوان أهنأ من الإنسان بالا، وأروح منه حالا، فإنه يعيش في هناء وسرور، ولهو وحبور، فإذا جاء يومه اضطجع وأن أنينه، وذهب غير مأسوف عليه، ولا منظور إليه، ولم يأس على ترك ولد، ولم يحزن لفراق بلد، ولا ندبه أهل تركهم أشتاتاً، وشعب جمعهم أنكاثاً.
نظر الإنسان في أمره هذا النظر، فثارت في ضميره حرب عوان، واشتعلت في فؤاده نيران وأي نيران، ولم يهنأ له عيش، ولم يقر له بال على حال، حتى كرر النظر، وأعمل الفكر، وآب وفي طي ضميره عقيدة الخلود في دار بعد هذه الدار، وعلى حال غير هذه الأحوال، وأن بينه وبين الحيوانات فرقا شاسعا، وامتيازا كبيرا، فهي تأكل وتتناسل ثم تتلاشى وتفنى فناء لا نشور بعده.أما هو فيحيا هذه الحياة القصيرة الأمد في أي نوع من أنواع الجهاد الحيوي، ثم يفارق هذا العالم إلى عالم أرقى منه، فبنى على هذه الفكرة أخلاقه وآدابه، وأسس على دعائمها شرائعه وقوانينه، وسعى في كل أعماله أن يبتعد في أحواله وشؤونه عن عالم الحيوان .
يعترض علينا الروحيون، ويشمتد بنا الماديون. يقول ا لروحيون:" إن تفصيلك هذا في منشأ الاعتقاد بالدار ا لآخرة والخلود، يشير إلى أن هذه العقيدة حصلت للإنسان بالاستدلال لا بالفطرة، ولو تساهلنا في أصولنا لهذا الحد بلغ منا خصومنا الماديون مناهم، وحاربونا بنفس مقرراتنا، وأثبتوا لنا أن الدين مبدؤه إنساني لا إلهي. فما تقول؟". ويقول لنا الماديون:" لقد رجعتهم إلى أصولنا الصحيحة المستندة على الحقائق الثابتة، وقلتم أن الدين نشأ للإنسان بالاستدلال والنظر في الكون".
نقول: إنا لا نريد من فطرية الدين أنه مطبوع في وجدان الإنسان على شكل خاص، وإنما نريد من ذلك أنه مستعد له بالفطرة. أي أنه إذا كان سليم الفطرة، صحيح الفؤاد، حاصلا على شروط الإنسانية توصل بمحض قواه ومواهبه الذاتية إلى الدين المطلق الحق، وهو الخضوع لقيوم السموات والأرض، ولكنه قد يكون سقيم الفطرة، مريض الفؤاد بالشهوات والسفاسف، فيميل بتلك الخاصية الدينية فيه إلى اعتقاد الأوهام والأباطيل، وما يحس من نفسه بالباعث إليه، كإرغام أكثر المتدينين أنفسهم على اعتقاد ما لا يقر عليه العقل، ولا يوافقه الحس، بل قد يعتقدون بالوراثة ما يخجلون من حكايته، ويبكون من شدة تناقضه. فلو كان قولنا الدين فطري في النفس، معناه الدين على شكل خاص لما اختلف كلهم فيه، ولكان دين البشر واحداً، ولكنا نريد من قولنا الدين فطري في النفس، أنها مستعدة له بالفطرة.
قلنا، معنى قولنا الإنسان مفطور على الدين، أنه مستأهل للتدين وقابل له بالفطرة، ومعنى قبوله له أن في طبيعته بواعث تبعث له، وتؤديه إليه. فهب أنك ربيت طفلاً بمعزل عن الناس، فلم يسمع أقوالهم، ولم يتأثر بعقائدهم ولم يحصل خبراً ما عماهم عليه من حيث الدين بالمرة. فلا يلزم من قولنا أن الإنسان مفطور على الدين أنك ترى ذلك الطفل متى بلغ سن التمييز ناطقا بحقيقة الدين الكبرى بلا مقدمات ولا نتائج. كلا ، بل قولنا ذلك يقتضي أن قواه ومواهبه الفطرية لا تزال به حتى تؤديه إلى الدين ولو بعد حين، وذلك أنه متى بلغ سن التمييز أخذ ينظر في الأشياء المحيطة به نظر المميز المستخير، يرفع بصره إلى السماء فيستعرض تلك النقط اللامعة في وسط ذلك الأديم الأزرق، ثم يرمي به إلى الأرض ويستجلي بدائع الأشجار وغرائب الأزهار وعجائب الأطيار؛ ثم يؤوب إلى ذاته فيسائل نفسه عن منشئها وأصلها، وكيفية نموها وتكونها، وهكذا، ثم يترقى في النظر والاستدلال بترقي سنه وتوالي المناظر والمشاهد على مخيلته، ويؤوب بشيء من العلم في كل مرة، حتى ينتهي به النظر إلى أصل الكون ومبدئه، وكيفية تصريفه وتدبيره، فلا يتمالك نفسه من الحكم البات الذي لا يعتريه شك، ولا يشوبه تردد، بأن له مصرفا قوياً، ومدبراً عالياً، يهيمن عليه، ويقوم بشؤونه، وبما أنه جزء من الكون يرى أنه هو أيضا صنع ذلك القوي القادر قيوم السموات والأرض.
إن الدين عام بين كل أمم الأرض، ولا يشذ عنه إلا أفراد متوحشون لا يعدون من الإنسانية، لأن فيهم نقصا فطريا، وقد ثبت أنهم غير قابلين للترقي. فكون الدين عاما في كل الأمم بعقيدتيه الرئيستين، الاعتقاد بالخالق والاعتقاد بالمعاد.
ويظهر من استقراء مدركات الإنسان في خلال القرون المتنائية، أن العقيدة بوجود الروح قديمة كقدم العقيدة بوجود الخالق جل وعز. وقد كان الأقدمون يزعمون أن للحيوانات روحا حساسة فقط لا عاقلة. وقد قرر فلاسفة اليونانيين القدماء بأن للكون كله روحا سارية في صميم كل ذرة من ذراته، وقد وضعت فيه لتقوم بتحريك أجزائه وتصوير كائناته، بمعنى أنها جعلت لتهب المادة الحركة والصورة. وقد كان فيتاغورس الفيلسوف اليوناني، وأفلاطون الشهير، والفلاسفة الإسكندريون، يعتقدون بأن روح الوجود مادة متوسطة بين الخالق الأقدس والكون المادي.
يظهر أن الأقدمين كانوا لا يعرفون الروح إلا مادة لطيفة، وما كانوا يدركون المعاني الملكوتية القدسية، ولذلك لما أرادوا تعريف الروح بحد قالوا أنها من جوهر لطيف هوائي، وإن مثلها في هذا الغلاف الجسداني، كمثل الفراش يظل مسجوناً في غشائه حتى يتم له تكون جناحيه فيمزق ذلك الغشاء ويطير.
والنفس بعد خروجها من الجسد تصعد إلى عالم الأثير حول الكواكب الزاهرة في قبة السماء، وكان أفلاطون يدعي أنها محتد الأرواح قبل نزولها إلى الأجساد.
ولاعتقاد قدماء اليونان مادية الروح كانوا يرمزون لها بالصورة المادية. فكانوا يصورونها على شكل آدمية ذات أجنحة كأجنحة الفراش. وهذا الرمز يشاهد فوق التماثيل والأنصاب القديمة. وتارة كانوا يصورونها بامرأة محجبة متزوجة جديدا وفي صدرها صورة فراش.
كان الرومانيون مثل اليونانيين، يذهب قدماؤهم إلى مادية الروح وإن كانوا يعتقدونها خالدة. يظهر ذلك من نقوشهم على الأوسمة التي كانوا يسبكونها تذكاراً لجلائل وقائعهم، وعظائهم حروبهم. فكانوا يصورون نسرا وطاووسا طائرين في الهواء وهما رمزان للإلهين (جوبتير وجوتون)، وبين كل منهما نصف صورة إنسان، وهي رمز إلى روح الإمبراطور والإمبراطورة، صاعدين بها إلى السماء مقر الأرواح العالية.
وكانت عقيدة تناسخ الأرواح، أي انتقالها من جسد إلى جسد آخر شائعة عند أكثر الأقدمين، ولم تزل منتشرة عند أكثر شعوب المسكونة، وقد صار لها اليوم في أوروبا أنصارا كثيري العدد.
كان الأقدمون يعتقدون بالتناسخ على وجهين، تناسخ الروح الإنسانية في جسد إنسان يولد جديدا، أو تناسخ الروح الإنسانية في جسد حيوان أعجم. وإلى هذا كان يذهب فيتاغورس كما نقله عنه تلامذته . قالوا: إنه كان يعتقد بالتناسخ وأن النفس الفاضلة متى خرجت من جسم صاحبها تلبست بجسم شخص فاضل، وبخلاف ذلك، لو كانت شقية، فإنها تتقمص جسم حيوان قذر. وكان يقول أنه يتذكر الحالات التي كان فيها هو نفسه في أجساد مختلفة.
أما أفلاطون، فكان له مذهب خاص في مسألة الروح وأصلها، فقد كان يعتقد بأن أصل الكون صور عقلية معنوية أزلية، كون الخالق على حسبها جميع الكائنات الحية والجامدة.
وكان يقرر أن للعقل ثلاث خصائص، وهي: الإحساسات ، والمدركات، والمعقولات. فالإحساسات تقابل الأشياء المتغيرة والمتشخصة، والمدركات تقابل الأياء المتغيرة ولكن مع تجريد أشخاصها من الحس بها، أما المعقولات فتقابل الأشياء الثابتة، والحقائق العامة. وعنده أنه المعقولات في ذاتها ليست مدركات بسيطة للعقل ولكنها أصول الأشياء وحقائقها، بمعنى أنها كل ما في الكائنات من حق وباق وعام. وكان يقول أنها عالم قائم بذاته فوق عالم الكون والفساد، وهي واصلة إلينا من الله مباشرة وهي القوالب التي شيأ الله تعالى عليها الأشياء.
ولما كانت المعقولات على رأي أفلاطون، هي الأشكال الحقيقية السرمدية لكل ماهو موجود فقد سماها (بالنموذجات).
قال أفلاطون: يوجد خارجاً عن الله تعالى أًصل متغير ناقص قابل للفناء موجود بذاته هو هذه المادة العمياء الصماء التي لا شكل لها ولا صورة ، فبأثر من الله تعالى أوقعه عليها ازدوجت هذه النموذجات التي هي المعقولات المجردة بالمادة عديمة الصورة والشكل على درجات مناسبة، منها جوهر متوسط مشترك بين خصائص كل من هاتين الطبيعتين. وهذا الجوهر هو روح العالم. فروح العالم هذه بتشخيصها وانقسامها إلى أرواح مختلف تكون الآلهة التي يعبدها العامة، وتولد الناس، وهم الكائنات المتمتعة بعقل وإدراك. وفي رأيه أن الكون المادي مكون من عنصرين متضادين: التراب وهو أصل لجمود العالم وصيرورته محسوسا، والنار وهي سبب كونه مرئيا. هذان العنصران الترابي والناري ملتئمان ببعضهما بواسطة عنصرين وسطين بينهما، هما: الهوا ءوالماء، وهما من جهة متشابهان في صفة مشتركة هي السيالية، ومن جهة أخرى كل منهما مشابه للطرفين الآخرين، فالهواء يشبه النار والماء يشبه التراب.
أما روح الإنسان في نظر الفيلسوف، فهي حياة غير قابلة للفناء محصورة في سجن فانٍ هو جسد الإنسان، وهي متمتعة بثلاث قوى مختلفة: الإدراك أي العقل، والقلب أي الشجاعة ، والرغبة أي الشهوة. فأما الجزء السامي من النفس التي هي حية بالمعقولات والمطالب التي توافقها وتلائمها فمحلها الرأس. أما الشجاعة فموطنها القلب. وما سفل من قوى النفس فموضعه الأمعاء.
أما مذهب أرسطو في النفس فلا يمكن الوقوف عليه بالدقة لتناقض تلامذته في أصوله الأولية التي نقلوها عنه. فقد قالوا أن مبدأ فلسفته هذه القاعدة" لا يصل إلى العقل إلا ما يمر أولاً بالحواس الخمس" وهي قاعدة كما قلنا عند كلامنا على فلسفته، تجعل الحواس أصلا للمعقولات، ومنبعا للمدركات..
كان أرسطو يرجو أن يؤسس مذهبا وسطا بين المذهب العقلي الفكري، والمذهب المادي الحسي، وهو مسعى عظيم لو استطاع إليه سبيلا، ولكن غاب عنا الآن شكل ذلك التوسط الذي أتى به هذا الفيلسوف، وقد وقع فيما وقعنا فيه من الحيرة كثير من أتباعه فوقعوا في المذهب الحسي المطلق.
والذي يمكن استخلاصه من الأقوال الكثيرة ، أن مذهب أرسطو يفرض للعقل الإنساني جزأين متميزين عن بعضهما تمام التمايز، وهما الأشكال العقلية والأصول التي تتأثر بها الحواس من الخارج. فالعقل بما وهب من تلك الأشكال الأصلية فيه، يصدر أحكاما عامة ضرورية يصبغ بها المتغير والشخصي بصبغة الضروري العام، كإدراكه استحالة المستحيلات وجواز الجائزات، ولكن هذه الأشكال العقلية التي تصدر منها، تحتاج لمادة تنطبق عليها هذه المادة بهيئتها الإحساس والتجربة.
إذا تقرر هذا، يعلم من أول وهلة أن مذهب أرسطو يوافق من بعض الجهات مذهب أفلاطون، ويلائم مذهب أبيقور من جهات أخرى. ولكن مع حفظه شخصيته وصونه استقلاله عن كليهما.
أما موافقته لمذهب أفلاطون، فذهابه إلى وجود عنصر في العقل الإنساني يتميز تمام التميز عن الإحساس، وأما موافقته لمذهب أبيقور فلتسليمه بأنه لولا الإحساس لما أمكن الإنسان أن يعلم عن الوجود شيئا، ولا أن يحصل عنه خبرا. أما كونه مع ذلك حافظا لشخصيته صائنا لاستقلاله فلكونه يبتعد عن كلا هذين المذهبين بعدا شاسعا في بقية مستلزمات هذه المبادئ، فإن أفلاطون يذهب إلى أن (المعقولات) التي هي منابع الأحكام المطلقة، هي حقائق أبدية، مستقلة عن العقل، وخارجة عنه، ومشرقة عليه فقط، ويذهب أبيقور إلى أن أحكام العقل ليست إلا تعميما لإحساس الحواس.
المرجع:
ص ص : 415-407
الإسلام في عصر العلم، محمد فريد وجدي، دار الكتاب العربي، بيروت: لبنان، الطبعة الثانية، 1967م