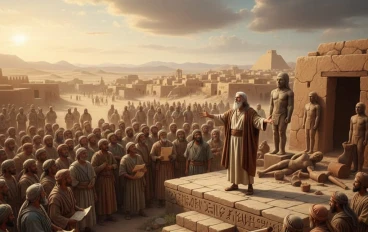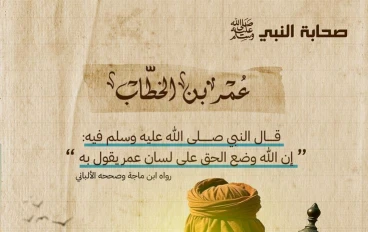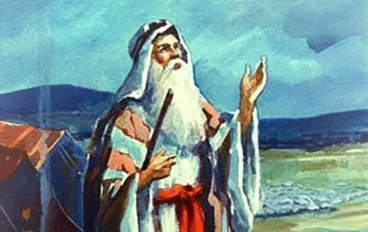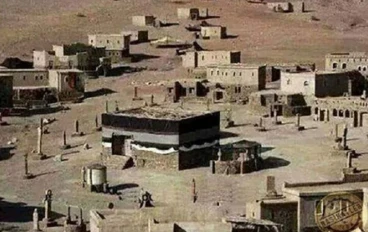الحياة الاجتماعية في العصر العباسي
حين نعرض للحياة الاجتماعية في العصر العباسي، يتبادر إلى ذهننا قوة التدخل الأعجمي، التي عمدت إلى هدم الأساس العربي المتتالي زخمه، حتى نهاية الحكم الأموي. فقد تسربت الأداة الفارسية، بيدٍ طويلة المنال، لإزالة كل قديم أصيل، وإدخال ما هو غريب عن المد العربي. وقد عمد الأعاجم إلى إفساد الدم العربي، بدفع نساءٍ أعجميات، ليصبحن زوجاتٍ للخلفاء، ويلدن أولياء العهد، الذين سيصبحون حكام المستقبل وأصحاب السلطان. وإذا استثنينا أبا العباس السفاح، والمهدي والأمين، فإن الآخرين من الخلفاء، لم يكونوا أبناء حرائر من النساء.
ومما ساعد على اختلاط العنصر العربي، بسائر العناصر في الشعوب المغلوبة، تعدد الزوجات، والتسري، وتجارة الرقيق، الأمر الذي أدى إلى فقدان العرب مكانتهم الرفيعة، ومرتبتهم المجردة من كل زيغ. ولم يكن بالغريب، أن تلمح في سدة الخلافة، أنصاف العرب، والمهجنين من ليسوا في العير أو النفير.
وهذا أدى إلى زوال الأرستقراطية العربية، وبروز طبقة من الموظفين من لونٍ غير عربي، يغلب عليه الطابع التركي، والفارسي، الذي تمثل في قول الشاعر:
إن أولاد السراري *** كثروا يا رب فينا
رب ادخلني بلاداً *** لا أرى فيها هجينا
وأخرجت المرأة عن نطاق الحرية التي كانت تتمتع بها في العصر العباسي الأول، حين بسط البويهيون نفوذهم، في أواخر القرن العاشر الميلادي . فبسط على وجهها الحجاب، وعزلت عن الرجال. وفي حقبة الانحطاط السياسي المتميز، بسقوط مستوى الآداب الجنسية، وكثرة الأنغماس في الملذات والتهتك؛ هوت المرأة إلى الدرك الأصفل في المكر والدسائس ومستودع الفساد.
ونستطيع أن نقف على مقاييس الجمال النسائي الشائعة في هذا العصر، من ألسنة الشعراء، الذين جعلوا أحسن القدود ما كان كالخيزران، وأجمل الوجوه ما كان كالبدر استدارة، وأجود الشعر ما حاكى الليل سواداً، وأحب ألوان الخدود، البياض مع الحمرة، ويزداد الخد جمالاً إذا توسطه خال. وقد أحبوا في المقلتين الكحل الطبيعي دون التكحيل. وشبهوا العيون الكبيرة يعيون المها. وقالوا في الجفن المتكسر: ناعساً سقيماً. ووصفوا المبسم بالإقحوان. وجعلوا الأسنان فيه كعقد اللؤلؤ، أو كالبرد. والنهدين كرمانتين . والخصر كقضيب. والردف ككثيب.
واستحسنوا الأصابع الدقيقة الرخصة الأنامل المستدقة الأطراف.
وكان الأثاث ديواناً للجلوس، يمتد حول بعض جدران الغرف المفروشة بالسجاد. والمقاعد تأخذ شكل الكراسي. وانتشرت الوسائد المفروشة على طرايح. وكان الأكل يقدم وسط أطباق نحاس مدورة، على موائد واطئة أمام الدواوين، أو على الأرض مقابل الوسائد. وفي منازل الأغنياء، يقدم الطعام على أطباق مصنوعة من الفضة.
وتوضع الطباق فوق موائد من الخشب المرضع بالأبنوس. وانتشرت الأطعمة الفارسية: كالسكباج المصنوع من مرقٍ مخلوطٍ باللحم والخل.
وكالدجاج المعلوف بالجوز المقشر واللوز. وكالفالوذج، وهو أحسن أنواع الحلواء. وصارت المنازل تبرد بالثلج في فصل الصيف. وتدار فيها المرطبات المصنوع من الماء المحلى بالسكر، والمقطر بمعصور البنفسج والموز والزهور، أو بمعصور التوت. وانتشر شرب الخمر بين الخلفاء والأمراء، والعامة من الناس. حتى القضاة، لم يحفلوا بأوامر الدين، وأقبلوا على شربه. وقد تسابق الخلفاء إلى التنافس في طلب العلماء والشعراء والمغنين وأرباب الموسيقى؛ واتخذوهم ندماء لهم، يقارعون معهم كؤوس الخمرة المصنوعة من التمر. وكانوا يتحلقون في حلقات تسمى مجالس الشراب.
وقد درج الداعون إلى الشراب، أن يعطروا وضيوفهم لحاهم بالمسك وماء الورد، ويرتدون ثياب المنادمة، بينما تتضوع أرجاء الغرفة، برائحة العنبر والند المشتعل، حيث تطوف به القيان والغواني المحترفات الهوى. واكثر الغواني، من بنات الرقيق، يتخذن مغنيات، وراقصات وسراري. وكان لبعضهن نفوذ عظيم على أسيادهم الخلفاء. فقد حُكي عن الرشيد، خبر شراء جاريته ذات الخال بسبعين ألف درهم. وقد هاجته الغيرة ذات يوم فوهبها لوصيفه: حمويه. وبعد أن وهبها عاد فاشتاق إليها ، فاسترجعها من وصيفه، وحلف ألا تسأله حاجة إلا قضاها؛ ولم تخيب أمله، فطلبت منه، تولية (حمويه) الحرب والخراج بفارس، مدة سبع سنين فلبى طلبها. يضاف إلى ذلك، نادرة ثانية، تتعلق بشغف الرشيد، بجارية اسمها دنانير، كانت مولاة ليحيى بن خالد البرمكي، فأخذ يتردد عليها، ويقيم عندها ويبرها. وما عتم خبرها حتى وصل إلى زوجته زبيدة، التي سعت أن تبعده عنها، بإهدائه عشر جوار منهن: مارية أم المعتصم، ومراجل أم المأمون، وفاردة أم صالح، وغيرهن من الجواري الأخر.
ويتبين أثر سطوة الجواري على الخلفاء، ما نقرأه على لسان شاهد عيان، دخل على المأمون في أحد الشعانين، فرأى بين يديه عشرين وصيفة، تزنرن وتزين بالديباج، وعلقن في أعناقهن صلبان الذهب، وفي أيديهن أغصان الزيتون.
فلم يزل يشرب، والوصائف يرقصن بين يديه حتى سكر. وللحال أمر أن يُنثر على الجواري ثلاثة آلاف دينار. وكان أكثر الخدم الذين دخلوا في خدمة الخلفاء والأمراء من الأرقاء، من شعوب غير مسلمة؛ انتزعوا قسراً من بلادهم، أو أسروا بالإضافة إلى ما تقدم، انتشرت الحمامات حول المساجد، لا لاستعمالها للوضوء والطهارة، بل للهو والترف أيضاً. وقد بُنيت على شكل قسمين: واحد يختص بالنساء، وآخر يخصص للرجال. وفي عهد الخليفة المقتدر، أحصي ما يقارب السبة والعشرين ألفاً من تلك الحمامات الشبيهة بما نراه اليوم. وكانت تحتوي على مخادع كثيرة، مفروشة بالفسيفساء، وقد طلي نصف حائطها مما يلي الأرض بالقار؛ وطلي النصف الآخر الأعلى بالجص الأبيض الناصع البياض.
وكانت تُبنى حول ردهة واسعة، عليها قبة فيها نوافذ زجاجية صغيرة مستديرة للنور. وفي كل مخدع حوض من الرخام فيه أنبوبان للماء الحار والبارد. أما الغرف الخارجية، فكانت للإتكاء والاستراحة، وتناول المشروبات وبعض الأطعمة وبالإضافة إلى ما تقدم، انتشرت الألعاب واللهو المنزلي، كالنرد والشطرنج. وقيل: إن الخليفة هارون الرشيد، أول من أدخل هذه الألعاب إلى قصر الخلافة.
وإذا كان قد ذكر بأن الرشيد، هو أول من لعب الشطرنج، وأرسله فيما أرسل من الهدايا إلى شرلمان ملك فرنسا، فمن الثابت أنه رسخ هذه اللعبة بين أفراد الطبقة الارستقراطية، فاعتاظت بها عن النرد الذي انتشر أولاً في منازلها.
وكلاهما – أي النرد والشطرنج – من أصل هندي. وانتشرت ألعاب أخرى، غير هذه التي ذكرنا، منها : الجوكان والصولجان، ولعب السيف والترس والجريد، وسباق الخيل. وكان من مزايا الندماء، ا لرمي في الأغراض وطلب الصيد، واللعب بالكرة، وهي صفات يساوي فيها الملك ندماؤه وبطانته ومن الخلفاء الذين أغرموا بلعب الكرة: الخليفة المعتصم. وهناك إشارات إلى لعبة الطبطاب.
وهي خشبة عريضة يُلعب بها. وهي شديدة الشبه بلعبة التنس المنتشرة اليوم، ولعلها كانت في شكلها البدائي. وكان الرشيد يُسر بمشاهدة سباق الخيل، ويعتز كثيرا إذا نالت خيله النصر، وكانت من السوابق، وانتشر الرهان بين الناس على الخيل في حلبات السباق، وكانوا يدفعون لأجل ذلك المبلغ الطائل من المال الذي يستحقه المراهن الرابح.
وكان للصيد ولعٌ كبيرٌ لدى الخلفاء والأمراء. ويُذكر أن الأمين ولع ولوعاً كبيراً بصيد الأسود. وكان له أخ شديد الولع بصيد الخنازير. وقد شغف كل من أبي مسلم الخراساني والمعتصم بصيد الفهود.
وكانت هناك مواضع خاصة، ينصبون فيها الشراك، ويروضون البزاة على الصيد المحكم الأهداف.
وقد دخلت تربية البزاة والبواشق، إلى المجتمع العباسي في بلاد فارس، ولا يزال العمل بهذا الصيد معروفا في إيران والعراق وسوريا. وكان يُستعان بالبواشق والبزاة، لصيد الغزلان والأرانب والحجل، والأوز البرّي والبط والقطا.
وكانت كلاب الصيد تستعمل لصيد الغزلان وغيرهما من الحيوانات المنتشرة في البر الصحراوي.
وهذا التمازج الاجتماعي الذي مر معنا، من خلال الجواري والغلمان وشرب الخمر، ودور اللهو والغناء. يضاف إلى ذلك، العادات المكتسبة من الفرس والترك والهند ... الخ. بالإضافة إلى الترف في المأكل والملبس والرياش والأثاث، والشرف في الحمامات، والصيد وما شابهه، الذي أدى إلى نشوء مجتمع جديد، تتجاذبه أهواء وميول مختلفةالنظم والمقاييس، ترتكز على دعائم طبقة واهية منها: الارستقراطية المتمازجة مع العرب الإقحاح . ومنها البرجوازية العربية المتداخلة مع غير المسلمة من الأقطار المجاورة. ومع الأعجمية المسلمة، وهي خليط من القيان والجواري، والمولدين والرقيق والغلمان، إلى جانب من كانت لهم المكانة الرفيعة في بلاط الخلفاء والأمراء.
وكانت الطبقة الارستقراطية، تتولى شؤون الجيش والعمل العسكري، أما الطبقة البرجوازية، فكانت تتولى الشؤون التجارية والصناعية، وما شابهها من أعمال الاستثمار. أما طبقة الخليط الشعبي، والعوام المختلف الأجناس فكانت تتولى المهن الحقيرة القليلة المردود.
وقد لعبت الطبقاتان: الارستقراطية والبرجوازية، دوراً فعالاً في نشر الخلاعة والعبث والمجون، الممتزج بالشعر المتهتك، والأدب الفاضح، وكان للغانيات، وبنات الهوى، من الجواري الهنديات والروميات والتركيات، المتلقحات بالثقافات المتعددة المذاهب، أثر كبير في نشر ضروب الفسق المتهتك السلوك والغاية كما كان لهن الحظ الأوفر، في بسط أنواع من الظرف والفكاهة والتندر، بحب الزهور والرياحين، ووصف فعل السحر من منظرها، والنشوة من تنشق أريجها العابق بكل طيب. وفي بسط عادة كتابة الشعر، والجمل المستملحة على الأقمصة والأردية، والأكمام . وهذا كله، دخل في الظرف المستملح عادة وتقليدا في المطعوم والمشروب والملبوس، وكل ما يمت بصلة لذلك. وكان للخلفاء العباسيين، الدور الفعال في نشر تلك العادات والتقاليد. وما صاحبها من مستظرفات وهوايات، ومغالاةٍ في انتشار المجون " وما لف لفه". ومن قبيل ذلك، كان المهدي يطرب لسماع المغنيات، في حلقات الفكاهة والطرب المستظرف ، بشتى أنواع الجمال الخلاق، في وصف خمائل العشاق، المكللة بالزهور والورود، ورياحين الطيب والآس، والمنتشرة المعاني وتعدد الأسماء بأعذب إيقاع من رقيق اللحن، وشدو الغناء، على جرس المعاني البهيجة المفرحة.
ومن أثر ما اعتمده الخلفاء، أخذ الأغنياء والمترفون طرق لهوهم وطربهم، أمثال أبي عيسى بن هارون الرشيد، وإبراهيم بن المهدي ( 224هـ/ 839م) المعروف بسرعة بديهته، ودقة علمه بالنغم والوتر والإيقاع، وتعلقه بالصوت الحسن الرخيم. وقد أقيم في مجالس عامرة، بمطارحات اللهو، لمثل من ذكر، احتفالات أنسٍ وإمتاع، داخل قصورٍ ترفل بما لذ وطاب. وقد وصف أبو العتاهية (212هـ/ 825م) وصفاً غنياً بالروعة والإبداع، لأنواع الفواكه والرياحين، والألوان المختلفة من النبيذ المعتق.
وكان للجنائن والرياض والحدائق والبساتين، المكان الأوفى والأعلى في وصف شعراء ذلك العصر. فقد كان الماء والخضراء توأمين للوجه الحسن، في قصائد الشعراء المولعين بحب الطبيعة، وما نبت فيها من جميل الورد والزهر المزين للموائد والدور، والردهات الواسعة الرفاهة والجميل في هذا المجتمع المتقدم، أنه صبغ الحياة العامة، بصيغة محاسن الوصف، المتغلغل في النفوس.
وهذه الصبغة، نفذت بأريج عطرها إلى جمهرة الناس، فضلا عن خاصتهم، وأخذ الشعر يرسم على منوالها، ويحذو حذوها، وينفذ إلى أعماق حياة الناس، معبرا عن حياتهم، واصفا لمجتمعهم، مصورا أحوالهم، بحيث تحول الشاعر إلى راصد لحياة زمانه، وكأنه عالم اجتماع؛ غير أنه عالم شاعر، ووصاف ماهر، ومعاشر لبق يحسن رصف الكلام في حديثٍ طلي.
وعندما شاع الغناء – وسط هذا المجتمع – كان هناك المغني المجيد، والقينة المحسنة عزفاً وغناء. وكان الشاعر يجلس إلى واحدةٍ من القيان المبدعات الضرب، المتشحات بغلالات من الدمقس، تتدرج من قمة رأسها ، متهدلة على جانبها، فيأخذ شكلها وعزفها وأوتارها بمجامع خاطره، فيقول فيها على سجيته الشاعرة:
وجاريةٍ تنال النفس منها *** بلجظ العين غاية ما تمنت
تريك الحسن والإحسان وقفاً *** إذا برزت لنا وإذا تغنت
كأن العود حين تمس منه *** يعبر عن سرائر ما أجنت
كأن ترنم الأوتار فيه *** أنين مشوقةٍ ذكرت فحنت
والشعر في وصف المغنين والقيان كثير وفير. جيد أكثره. والغناء والعزف – في أغلب الأحيان – مقرونان بالرقص، وما شابهه على هذا الصعيد. وعرضنا لحياة الغنى والترف – في هذا العصر – لا ينفي وجود الفقراء، وما يعانون من إرهاق ارتفاع الأسعار، والغلاء المدون في قصائد الشعراء، الذين يذكرون الأغنياء بالضغط المفقر، المتسلط على أعناق إخوانهم المعوزين، وما يصيبهم منه من ألم وعذاب شاق مرير وانتشار آلام الفقر والجوع، أوجب انتشار حياة الزهد الداعية، إلى نبذ الإغراق في الملذات، والجري وراء الشبهات، في سبيل متعةٍ قانية، تبدد بانتهاء ، آنيتها السريعة الزوال.
وكان الناس يشاهدون دعاة يطوفون الشوارع، وقد أرسلوا اللحى الطويلة، ولبسوا ما خف ثمنه من الثياب، وهم يهتفون بأصحاب المال، أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله، ليخلصوا من عبء مسؤوليته يوم الحساب. وكانوا يدفعون الموسرين، إلى التخفيف من غلواء الجري – وراء المادة المسببة لأصحابها ضياعاً في الإغراق بسفاسف المجون المفرط في الابتذال، والخلاعة الموصلة للزندقة المنحرفة السلوك والمنطق.
وهذه الأخيرة – أي الزندقة – كثر شيوعها في العصر العباسي، وأصبحت عبئا ثقيلاً ، حث الخلفاء على مقاومة حركاته، الهدامة البغيضة الغاية. ومن هؤلاء الخلفاء، المهدي الذي وصل به الأمر، إلى تعيين رجل، أوكل إليه أمر مروجي مظاهر الزندقة المسرفة التطرف. والحالة ذاتها مارسها الهادي والرشيد، اللذان أكثرا من ملاحقة مروجي تفاسير قرآنية، وأحاديث نبوية ينبذها الإسلام – ويتبرأ من تأويلها المناقض للواقع. وشيوع الزندقة في العصر العباسي، ملأ كل تجمع يؤول التفسير عكس ما هو أهل له.
وكان أهل الشعر، أول من جعل عيون الناس تتفتح، على هذا النوع من الانحراف المغرق في الاستهتار، والذي جعلهم يطلقون على صاحبه، معنى الزنديق المارق من الدين. وكان الشعراء، يفتقون في كل مجتمع فتقاص، يثير عليهم المتدينين، الذين يلاحقونهم باللعن والسباب، ليرعووا عن غيهم ويثوبوا إلى رشدهم، ويمتنعوا عن إنشاد شعرهم المليء بالتهكم والسخرية اللاذعة. وفي الوقت ذاته، كنا نلمح طائفة من الناس، لا ترى في إباحية الشعراء، سوى شيء من التلمج، الحافل بالطرافة والفكاهة. وما الزندقة التي يثور بسببها المحافظون المغالون، سوكى لهوٍ بريء، يبغى أهله الترفيه عن الناس، والتخفيف من همومهم، ولا يقصدون الانحراف بهم عن عقيدةٍ أو دينٍ يتساوق مع ما يسعون إلى بلوغ مرتجاه.
وظهرت طائفة أخرى، ناقض رأيها ما جاء على لسان الأولى، ورأت في شعر التجديد، البعيد عما هو مألوف عند من التزموا القواعد الأخلاقية، تلاعبا فاضحا بعواطف الناس، وخدشاً لمشاعرهم الفياضة بالسعي وراء الكمال. إنهم يدعون التزامهم بالخط الإسلامي، الذي فيه ما فيه من مرج وظرف إباحة الدين، ولكنهم يميلون في باطنهم، إلى الأخذ بالنزعة الفارسية، ونشرها بين الناس، دون أن يحسوا بما أقدموا على أخذه ونحن، وإن كنا نرى، أن حركة الزندقة، وسط هذا المجتمع المتماوج باختلاف الأجناس والألوان، قد صبغت نفسها بصبغة التسلية والتلهي البريء، في حالة التتعتع بنشوة السكر العابر، عبر حانةٍ أو ملهى، دونما قصد للطعن بالدين، أو الانحراف بأحكام الشرع الحنيف، فإن ما أخذ عليها، لدى المراقبين، عن هم من أتباعها، هو التطرف من قبل المولدين خاصة، للرجوع بمعاني المجتمع الأدبي في شعرهم، إلى الشعوبية القائمة على هدم كل ما هو عربي، والعودة إلى المجوسية وأغراضها الوثنية. ومن الشعراء الذين اتهموا بتلك العودة وأغراضها، ابن المنذر (198هـ/804م) والحسن بن هانئ (190هـ/805م) والحسين بن الضحاك (250هـ/865م) وغيرهم من الذين حذوا حذوهم.
وإذا كانت الخلاعة، عنوان هؤلاء الشعراء، فإن الشعوبية، كانت اتهاماً لهم، ولمن هم على شاكلتهم من المولدين الذين يريدون أن يتساووا بالعرب، ومن المتطرفين من الأعاجم، الذين هالهم ما أصابهم من هزيمةٍ ومن خضوع، فراحوا يفتخرون على العرب، بأنهم أعرق منهم حضارة ومدنية، بينما كان العرب غارقين بالبداوة المظلمة. وقد وصل المتطرفون، إلى ذروة الحط من قدر العرب، حين تمكنوا من العربية، واستطاعوا أن ينشروا تآليفهم التي تبرز مثالب العرب، وتجعل عاداتهم في الدرك الأسفل من الانحراف والتخلف وليس أصعب على الباحث – حين يصل إلى دراسة الشعوبية – من الخوض في أسبابها، والتعمق في آثارها، التي تركت على تاريخنا، بصماتٍ محفوفة بالمخاطر، تدفع كل بناءٍ مصلحٍ، إلى ترك الحديث عنها، كي لا ينكأ جراحاً، من الخير لها أن تندمل، ويفجر فتنةً من الأفضل لها أن تنام.
المرجع:
أبو فراس الحمداني، للدكتور عبدالمجيد ال حر، الطبعة الأولى، 1996م، دار الفكر العربي، بيروت: لبنان.