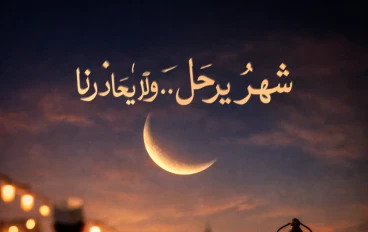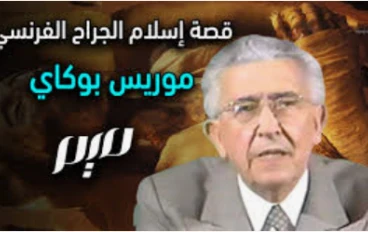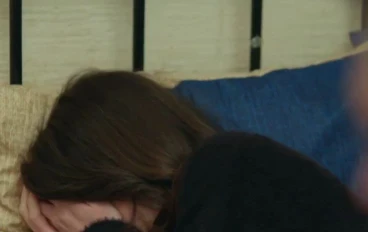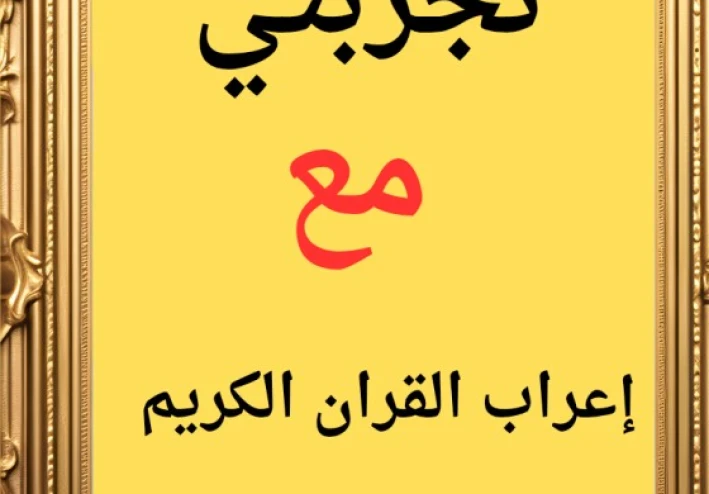
تجربتي مع إعراب القران الكريم
تجربتي مع إعراب القران الكريم
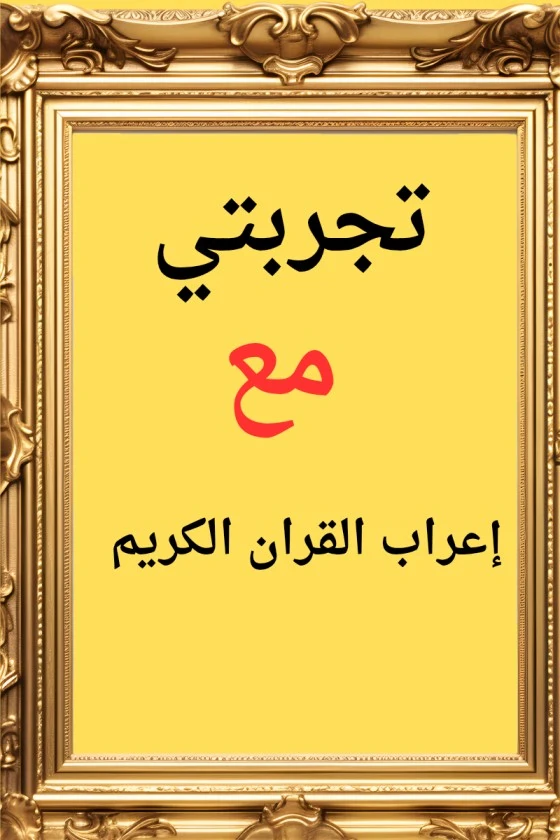
تجربتي مع إعراب القرآن الكريم ( 1 )
منذ أن بدأتُ رحلتي في تدبر القرآن الكريم، أدركت أن اللغة العربية ليست مجرد أداةٍ للتعبير، بل هي مفتاح لفهم كلام الله تعالى. فالإعراب — وهو علم يبيّن وظائف الكلمات في الجملة وصلتها بغيرها — لم يكن في نظري مجرد ترفٍ لغوي أو تمرين نحوي جامد، بل هو نافذة واسعة تطلّ على معاني القرآن العميقة، وتكشف عن دقائقه البلاغية التي لا تُدرك إلا بفهم موقع الكلمة وحركتها. ومن خلال تجربتي مع إعراب القرآن، تعلمت أن الحرف الواحد قد يفتح بابًا من الفهم، وأن الضمة والفتحة قد تغيران وجه التفسير.
أهمية الإعراب في فهم القرآن
الإعراب هو الميزان الذي يُضبط به المعنى، فبه نعرف الفاعل من المفعول، والمبتدأ من الخبر، وجواب الشرط من فعله. وقد قال العلماء إنّ أكثر ما يُستدل به على الإعجاز البياني في القرآن هو دقة التركيب النحوي، حيث تأتي الكلمة في موقعها بعناية تامة. والإعراب يُعين على كشف هذا التناسق، ويمنع من الخطأ في الفهم أو التأويل. فكثير من الآيات قد يختلف معناها باختلاف حركة أو موقع، ولهذا قال ابن مسعود: "أعربوا القرآن، فإنه عربيٌّ".
الأعراب لغة واصطلاحاً:
ومعنى الإعراب، لغة، الإبانة عمّا في النفس. وهو مصدر الفعل أعربَ. ومعنى أعرب أبان. يقال أعرب الرجل عن حاجته، أي أبان عنها. ومعنى الإعراب اصطلاحاً، هو تغيّر أواخر الأسماء المعربة والفعل المضارع تبعاً لتغيّر المعاني.
سنذكر في هذا المقال سبعة من أساليب الإعراب:
أولاً: فعل الشرط وجوابه:
فعل الشرط: في الجملة هو الفعل الذي يقع أولاً وهو شرط لحدوث جملة جواب الشرط.
• جواب الشرط: هو الفعل الذي يقع بعد فعل الشرط ويتحقق بوقوعه.
ويسبق فعل الشرط أداة شرط مثل إن ومَن وغيرهما.
مثال
إنْ تدرسْ تنجحْ
إن أداة شرط جازمة.
"تدرسْ": فعل الشرط، وهو مجزوم بالسكون.
"تنجحْ": جواب الشرط، وهو مجزوم بالسكون.
من أبدع ما يتجلّى في الإعراب القرآني ما تحمله آيات الشرط وجوابه من دقّة في البناء وعمق في المعنى؛ إذ إنّ كل شرط في كتاب الله هو باب من أبواب السنن الإلهية التي لا تتخلّف. فقول الله تعالى:
﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد:7]
يُبرز بوضوح ذلك الارتباط الوثيق بين السبب والنتيجة؛ فالنصر الإلهي مشروط بنصرة عباده لدينه، ولا يتحقّق الوعد إلا بتحقّق الشرط. فـ «إن» أداة شرط جازمة، و«تنصروا» فعل مضارع مجزوم بحذف النون، و«ينصركم» هو جواب الشرط مجزوم بالسكون. وبهذا البيان النحوي ينكشف لنا عمق العلاقة بين العمل والجزاء، والسنة الربانية التي تقضي بأن الجزاء من جنس العمل.
وكذلك قوله تعالى:
﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا﴾ [النساء:30]،
ففيه تهديد لمن تجاوز حدود الله، إذ إن فعل العدوان والظلم هو الشرط الذي يترتب عليه العقاب الإلهي. ومثلها الآية الكريمة:
﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ [آل عمران:120]،
وإن شرطية، وتصبروا فعل الشرط، وعلامة جزمه حذف النون ويضركم جواب الشرط. فجاء الإعراب ليُظهر أن الأمن من كيد الأعداء مشروط بالصبر والتقوى معًا، لا بأحدهما دون الآخر.
وهكذا يعلّمنا الإعراب أن أدوات الشرط كـ «إن»، و«مَن»، و«مهما»، و«أينما» ليست حروفًا جامدة، بل مفاتيح تفتح أبواب الفهم عن حكمة الله في أقداره، وربط الأسباب بمسبّباتها.
ثانياً: فعل الطلب وجوابه:
ومن بدائع البيان القرآني ما يُعرف بــ «فعل الطلب وجوابه»، وهو قريب من أسلوب الشرط.
فمن أبرز أدوات الطلب : الأمر (افعل)، النهي (لا تفعل)، الاستفهام (هل تفعل؟) ، التمني (ليتَ)، الترجي (لعلّ)، العرض (ألا)، والتحضيض (هلّا).
يُجزم الفعل المضارع إذا كان جواباً للطلب المتقدم عليه، وذلك بتقدير أداة الشرط (إن) وفعل الشرط.
مثال:
“لا تسرعْ تصبْ بأذى”، حيث “تصبْ” فعل مضارع مجزوم لكونه جوابًا للنهي) الطلب). الفعل تسرعْ هنا مجزوم على تقدير " إن تسرعْ تصبْ بأذى"
وفي قوله تعالى:
﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران:31] ،
نجد أن جواب الطلب «يحببْكم الله» جاء مجزومًا لأنه مترتب على الفعل «فاتّبعوني»، فاتباع الرسول ﷺ سبب لمحبة الله لعباده.
وكذلك في قوله جلّ شأنه:
﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر:60] ،
تتجلّى رحمة الله ووعده الكريم؛ إذ جعل الدعاء سببًا للاستجابة، فأتى الفعل «أستجبْ» مجزومًا لأنه جواب للأمر «ادعوني». وهكذا يربّي القرآن المؤمن على الارتباط الوثيق بين الطلب والعمل، وبين الرجاء والمسارعة في الطاعة.
ثالثاً: القسم وجوابه:
القسم هو أسلوب توكيد تُستخدم فيه جملة لتأكيد معنى جملة أخرى، ويتكون من ثلاثة أركان أساسية: أداة القسم (مثل الواو، الباء، التاء، أو فعل كـ "أقسم")، والمُقسَم به (وهو الاسم الذي تُؤدّى به اليمين، ككلمة الله)، وجواب القسم (وهو الجملة التي يراد تأكيدها).
مثال:
والله لا يخزيك الله أبداً.
أداة القسم: الواو.
المقسم به: الله.
جواب القسم: لا يخزيك الله أبداً.
وأمّا القسم في القرآن الكريم، فهو من الأساليب التي تعلو بها بلاغة الوحي، إذ يُقسم الله بما شاء من مخلوقاته تعظيمًا لشأن المقسَم به وتنبيهًا على أهمية المقسَم عليه. يقول تعالى:
﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر:1-2] ،
فالقسم بالزمن «العصر» يلفت الأنظار إلى خطورته وقيمته، ويأتي جواب القسم مؤكّدًا بـ «إنّ» واللام: «إن الإنسان لفي خسر»، ليدلّ على أن الوقت هو ميدان العمل، وأن ضياعه خسران مبين.
ومثله قوله تعالى:
﴿وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3)﴾ [الضحى:1-3] ،
فالقسم بالضحى والليل يحمل في طيّاته تسلية للنبي ﷺ، وجواب القسم جاء نفيًا للوداع والجفاء، وفيه من اللطف الإلهي ما يشرح الصدر.
إن أدوات القسم في القرآن — كالواو والباء والتاء — ليست مجرد حروف توكيد، بل هي جسرٌ يربط السماء بالأرض في خطاب جليل يرسّخ الحقائق في القلوب.
رابعاً: النداء والدعاء:
يُعدّ أسلوب النداء في القرآن من أرقى أساليب الخطاب، إذ يجمع بين العظمة والرحمة. فالمنادى يُنصب أو يُبنى على الضم بحسب نوعه.
مثال للمنادى المنصوب:
يا أبا بكر تقدم.
"يا" حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. و"أبو" منادى منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف. و"بكر" مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة.
مثال للمنادى المرفوع:
يا فاطمةُ أجلسي.
فاطمة: منادى علم مبني على الضم في محل نصب.
يقول الله تعالى:
﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ﴾ [المائدة:68] ،
أهلَ منادى منصوب لأنه مضاف والكتاب مضاف اليه.
فجاء النداء هنا توبيخًا وتعليمًا، بينما قوله تعالى:
﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [الأحزاب:32] ،
هو نداء تشريف وتكليف معًا.
ومن لطائف النداء قوله سبحانه:
﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ﴾ [الزمر:53] ،
عباديَ: منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الياء والياء مضاف إليه.
فهو نداء عام يشمل العصاة كلهم، يفتح لهم باب الرحمة الواسع.
أما النداء المبني على الضم فيظهر في اسماء العَلم كقوله:
﴿يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ﴾ [هود:48]،
نُوحُ منادى مبني على الضم في محل نصب على النداء.
ويظهر في النكرات المقصودة كقوله:
﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء:69] ،
نار منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب،
وفيه خطاب مباشر لمخلوق بعينه بأمر إلهي نافذ.
وأما لفظ الجلالة في قوله: «اللَّهُمَّ»، فهو منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم المشددة في آخره عوض عن حرف النداء «يا»، أي «يا الله»، وهو أسمى نداء وأجلّ دعاء.
خامساً: ظرف الزمان:
من أكثر الظروف ورودًا في كتاب الله الظرف «إذ»، إذ يُستخدم لاستحضار أحداث ماضية عظيمة في تاريخ الرسالات، فيأتي غالبًا بمعنى «اذكر»، كما في قوله تعالى:
**﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ﴾ [البقرة:30] ،
﴿إذ﴾ اسم زمان مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره ﴿اذكر﴾.
فالمعنى: واذكر حين قال ربك، وفيه تذكير للسامع بعظمة الخلق الإلهي وبداية التكليف.
أما الظرف «إذا» فيدل على المستقبل، ويشي بمعنى الترقّب لما سيأتي، كما في قوله تعالى:
﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر:1]،
إذا: اسم شرط غير جازم، مبني على السكون في محل نصب ظرف لما يستقبل من الزمان، وهو مضاف دائما إلى جملة بعده .
فسبّح هو جواب الشرط في قوله : فسبّح بحمد ربك واستغفره.
وبهذا التدرج الزمني ينتقل السياق من البشارة بالنصر إلى الأمر بالتسبيح شكرًا على تمام النعمة.
سادساً: الحال:
الحال اسمٌ نكرةٌ منصوب، يبيّن هيئةَ الفاعل أو المفعول به، أو كليهما، عند وقوع الفعل.
مثال:
خرج الرجل مسرعاً.
مسرعاً حال تبين حالة الرجل عند خروجه. ونوع الحال مفرد.
إعراب الحال يكون دائمًاً منصوبًا، وتختلف علامة النصب حسب نوع الكلمة، فالفتحة تُستخدم مع المفرد وجمع التكسير، والياء مع المثنى وجمع المذكر السالم، والكسرة بدلًا عن الفتحة مع جمع المؤنث السالم. قد يكون الحال مفردًا، أو جملة (اسمية أو فعلية)، أو شبه جملة (ظرف أو جار ومجرور).
الحال في القرآن الكريم صورة ناطقة تصوّر هيئة الفاعل أو المفعول ساعة وقوع الفعل، فتزيد المعنى وضوحًا وبلاغة. ومن ذلك قوله تعالى:
﴿أَیُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن یَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِیهِ مَیۡتࣰا فَكَرِهۡتُمُوهُ﴾ [القصص:21]،
ميتاً حال مفرد.
وكذلك قوله سبحانه:
﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة:60]،
فكلمة «مفسدين» حال منصوبة بالياء لأنها جمع
م مذكر سالم، تكشف هيئة القوم الذين تجاوزوا حدود الله.
سابعاً: الصفة:
إعراب الصفة والموصوف يتبع قاعدة "التوابع"، فالصفة (النعت) تتبع الموصوف في الإعراب (رفعاً ونصباً وجراً)، والتعريف والتنكير، والعدد، والتذكير والتأنيث.
مثال:
رأيتُ كوكباً منيراً.
منيراً صفة للكوكب وقد تبعته في النصب.
وفي الآية: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا} [الفتح: 1]
الموصوف هو "فتحًا"، والصفة هي "مُبِيْنًا" وهي كلمة واحدة تصف الفتح.
الآية: {وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عصِيبٌ} [هود: 77]
الموصوف هو "يوم"، والصفة هي "عصيبٌ".
الآية: {أَلَا بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [هود: 44]
الموصوف هو "القوم"، والصفة هي "الظالمين".
اإن تأمل التراكيب في القرآن يجعل القارئ
يدرك أن النحو ليس علمًا جافًّا، بل أداة لفهم روح النص، وإدراك مقاصده، ورؤية المشهد القرآني حيًّا متحركًا أمام عينيه.
كيفيّة الانتفاع من هذه التجربة:
سعيتُ في هذا المقال إلى أن أُطلعكم على خلاصة تجربتي في تدبّر إعراب كلام الله العزيز، راجيًا أن تكون نافعةً لمن أراد أن يسلك سبيل التأمل والفهم. وقد اقتصرتُ على ذكر أيسر ما يمكن من وجوه الإعراب للأسماء والأفعال، ليكون القارئ على بيّنة من موضع الكلمة في السياق القرآني، دون إطالة تُذهِب لذّة الاكتشاف. كما أوردتُ اسم السورة ورقم الآية، تيسيرًا لمن أراد الرجوع إلى كتب التفسير أو المواقع والتطبيقات المختصّة للمزيد من البيان والتفصيل.
ومن أبرز ما انتفعتُ به في رحلتي هذه موقع الباحث القرآنيhttps://tafsir.app/ ، إذ يضمُّ ثروة من كتب الإعراب الموثوقة. وأرى أن البداءة تكون بالبحث في إعراب الكلمة ضمن "التفسير الميسّر"، فإن لم يتضح المعنى، يُنتقل إلى" تفسير داعس"، ثم إلى " تفسير الدرويش"، فهو أوسعها مادة، وأغزرها شرحًا، وفيه دقائق البلاغة ومعاني الألفاظ التي تُبهِر القلب والعقل معًا.
وأنت تتلو آيات الله، فلا تمُرَّ على حركة رفعٍ أو نصبٍ أو جرٍّ دون أن تتأمل سرَّها، وتعلمَ موضعها في نظام الكلام الإلهي البديع. فالإعراب مفتاحٌ من مفاتيح الفهم، لا يُفتح بابه إلا بالصبر والمثابرة وطول المران، حتى يبلغ القلب لذّة التلاوة التي تمتزج فيها المعرفة بالتدبّر، والعلم بالخشوع.
وما زلتُ، بعد كل وِردٍ من التلاوة، أجد نفسي تعلقتْ بآيتين أو ثلاثٍ، أعود بهنّ إلى كتب التفسير لأتأمل إعراب كلماتهنّ، وأتعمّق في أسرار معانيهنّ. ولستُ أزعم أنّي جئتُ بأمرٍ لم يسبق إليه أحد، ولكنها محاولة متواضعة لأذكّر نفسي وإخوتي من المسلمين والمسلمات بأهمية الإعراب في تدبّر كلام الله تعالى وفهم معانيه على وجهها الأتم.
ولمن أراد أن يرسّخ أصول النحو ويُنمّي قدرته على الفهم، فثَمَّ موقعٌ تعليميٌّ متميّز يُعنى بتعليم النحو بأسلوب مبسّط وفعّال، وهو موقع توينكل.
https://www.tw inkl.com/teaching-wiki/
تطبيق عملي:
ولكي تتجلّى هذه المعاني في واقع التلاوة، فلنتأمل مطلع سورة الليل:
﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7)﴾ [الليل:1–7]
فهنا نجد:
- الواو : حرف قسم،
- القَسَم: والليل إذا يغشى،
- جواب القسم: إن سعيكم لشتى،
- أما: حرف شرط،
- الشرط: فأمّا من أعطى واتقى،
- جواب الشرط: فسنيسّره لليسرى،
- ظرف الزمان: إذا يغشى، إذا تجلّى.
إنها لوحة لبعض الأساليب الإعرابية التي يتجلّى فيها جمال البيان الإلهي وتناسق القواعد مع المعاني. ومن تدبر هذه التراكيب بوعيٍ وإخلاص أدرك أن علم الإعراب ليس ترفًا لغويًّا، بل طريقٌ إلى التدبر، ووسيلة لفهم سنن الله في خلقه وكلامه.
وبذلك تتحد اللغة والروح، فينطق اللسان بالعربية ويهتز القلب بالإيمان، وتغدو دراسة الإعراب عبادةً تُقرّب صاحبها إلى فهمٍ أعمق لكلام رب العالمين.
وقد اخترت سبعة من أبواب النحو والإعراب الأكثر وروداً في القرآن. وسوف أكتب إن شاء الله عن عدد آخر من الأبواب في المقالات القادمة.
خاتمة التجربة:
بعد سنوات من التدرّب على إعراب آيات القرآن، أدركت أن الإعراب ليس غايةً في ذاته، بل وسيلة لفهم مقاصد الكلام الإلهي. إن كل تركيب نحوي يحمل ظلالًا معنوية، وكل حركة تعكس بلاغة مقصودة. ولولا الإعراب، لضاعت كثير من الدقائق اللغوية التي تُظهر إعجاز القرآن في نظمه وتراكيبه.
لقد علّمني الإعراب أن القرآن لا يُتلى فقط، بل يُتدبَّر، وأن معرفة موقع الكلمة هي بداية الطريق إلى معرفة مراد الله منها. فكل من أراد أن يتذوق جمال القرآن ويغوص في أعماقه، فليجعل الإعراب رفيق رحلته في التدبر، فإنه المصباح الذي ينير دروب الفهم، ويكشف عن وجهٍ من وجوه الإعجاز لا يُدرك إلا بلسانٍ عربيٍّ مبين.